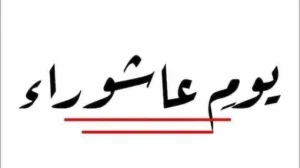الجذور التاريخية ليوم عاشوراء
يمتد تاريخ يوم عاشوراء في جذوره إلى ما قبل الإسلام، حيث كان يومًا معروفًا لدى العرب في الجاهلية. فقد كانت قريش تصوم هذا اليوم وتكسو الكعبة احتفاءً به، وكان اليهود في المدينة يصومونه احتفاءً بنجاة موسى من فرعون. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم عن السبب، فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه، فقال: “أنا أحق بموسى منكم” فصامه وأمر بصيامه.
التحول التاريخي: معركة كربلاء نقطة الفصل
كان الحدث الأبرز الذي غيّر مسار هذا اليوم هو معركة كربلاء في 10 محرم سنة 61هـ. ففي هذا اليوم استشهد الحسين بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلة من أهل بيته وأصحابه على يد جيش يزيد بن معاوية. هذه الحادثة المأساوية أصبحت محورًا للانقسام في فهم يوم عاشوراء بين المسلمين، حيث تحول من يوم صيام إلى يوم حزن عند طائفة، ويوم عبادة عند أخرى.
الموقف السني: التمسك بالسنة ومحاربة البدع
يتمسك أهل السنة بالهدي النبوي في التعامل مع يوم عاشوراء، مركزين على ثلاث نقاط جوهرية:
أولاً: الصيام المستحب الذي وردت فيه أحاديث صحيحة، منها قول النبي: “صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”. ويفضلون صيام التاسع معه مخالفة لليهود.
ثانيًا: يحذرون من البدع التي انتشرت حول هذا اليوم كالاكتحال والاغتسال والتوسعة في النفقات، والتي لم يرد فيها دليل صحيح.
ثالثًا: يرفضون تحويل اليوم إلى مأتم أو عيد، مستندين إلى قول النبي: “ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية”.
الممارسة الشيعية: من الحزن إلى الطقوس
تتخذ الطائفة الشيعية من يوم عاشوراء مناسبة للحداد والعزاء، حيث تتحول المشاعر إلى طقوس متعددة:
- تقام المجالس الحسينية التي تروي تفاصيل مقتل الحسين وأهل بيته بأناشيد رثائية مؤثرة.
- يمارس البعض اللطم على الصدور بضربات إيقاعية مصاحبة للأناشيد الحزينة.
- في بعض المجتمعات الشيعية، يصل الحزن إلى ممارسات كالتطبير (ضرب الرأس بالسيوف لإسالة الدماء) وتمثيل واقعة الطف.
- تستمر مراسم العزاء أربعين يومًا تنتهي بزيارة الأربعين إلى كربلاء.
الأبعاد العقائدية للخلاف
ينطلق الاختلاف من فهم مختلف لجوهر اليوم:
- السنة يرون أن صومه إحياء لسنة نبوية وتذكرًا لنجاة موسى.
- الشيعة يعتبرون صومه بدعة أموية، ويؤكدون أن الحزن على الحسين جزء من الإيمان.
- يرفض السنة الغلو في الرثاء، بينما يرى الشيعة أن البكاء على الحسين كفارة للذنوب.
- تتحول زيارة عاشوراء عند الشيعة إلى نصٍّ دعائي يتضمن مبايعة للحسين ولعنة لأعدائه.
السياق التاريخي للانقسام
يمكن فهم تطور هذا الاختلاف من خلال محطات تاريخية حاسمة:
في العصر الأموي، حاولت السلطة الحاكمة تحويل اليوم إلى مناسبة فرح، بينما استخدمه المعارضون رمزًا للاحتجاج.
في العهد العباسي، تبنى الشيعة يوم عاشوراء كأحد أهم رموز هويتهم المذهبية.
أما في العصر الصفوي، فقد تم تنظيم الطقوس الشيعية بشكل مؤسسي، وتحولت كربلاء إلى مركز ديني عالمي.
النقد المتبادل بين المذهبين
ينطلق النقد السني من مخالفة هذه الممارسات للهدي النبوي:
- النياحة المحرمة شرعًا والتي نهى عنها النبي.
- إيذاء النفس في التطبير الذي يناقض “لا ضرر ولا ضرار”.
- تحويل المصيبة إلى مناسبة للفرقة والشتات.
بالمقابل، يوجه الشيعة انتقاداتهم: - اتهام السنة باتباع “سنن بني أمية” في تحويل يوم الحزن إلى فرح.
- إغفال الجانب التضحوي في واقعة كربلاء.
- اختزال اليوم في صيام دون الالتفات لدروسه السياسية.
الأبعاد المعاصرة
تتجلى تأثيرات يوم عاشوراء في واقع المسلمين المعاصر:
- سياسيًا: تحول إلى أداة تعبوية في الثورة الإيرانية، ورمز للصراع الطائفي في بعض البلدان.
- اجتماعيًا: يشكل مواسم الحج الشيعي حراكًا بشريًا واقتصاديًا ضخمًا.
- ثقافيًا: أنتج تراثًا أدبيًا وفنيًا واسعًا من الشعر والمسرحيات والملاحم.
نحو فهم متوازن
يمكن تقريب وجهات النظر من خلال:
- الفصل بين الحدث التاريخي والممارسة الدينية.
- التركيز على القيم المشتركة كالعدل والتضحية.
- احترام مشاعر الطرفين مع تجنب الإيذاء.
- استخلاص الدروس من مأساة كربلاء دون تحويلها إلى أداة صراع.
كما قال الشيخ محمد الغزالي: “لو أراد الحسين أن يقدم نفسه قربانًا للإسلام، فلتكن تضحيته حافزًا للوحدة لا سببًا للفرقة”.
الخاتمة: بين الذكرى والذكر
يبقى يوم عاشوراء في الوجدان الإسلامي:
- مرآة لتاريخ الأمة بأفراحه وأتراحه.
- اختبارًا لوعي المسلمين في تمييز الثابت من المتغير.
- فرصة لإحياء قيم العدل والشجاعة والتضحية.
بين صوم الشكر وحزن القلب، يظل الدرس الأعمق هو تحويل الذكرى إلى طاقة بناء، تجعل من التضحية جسرًا نحو الوئام لا ساحة للانقسام.